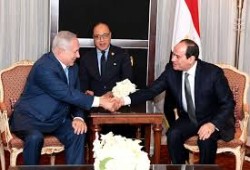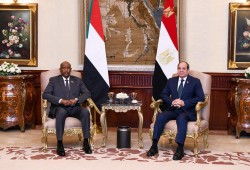بعد حرب الأيام الاثني عشر بين إسرائيل والولايات المتحدة وإيران، أشار كثير من المحللين - من يينهم الكاتب أندريا جيسلي - إلى أن استراتيجية الصين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات جوهرية، رغم أن بكين بدت في السنوات الأخيرة أكثر حضورًا وتأثيرًا في المنطقة.
ففي 2023، استضافت الصين مسؤولين سعوديين وإيرانيين للإعلان عن تطبيع العلاقات بين الرياض وطهران، واستقبلت الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، كما رحّبت بوفد خاص من السعودية ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وإندونيسيا لمناقشة غزة. وعقدت لاحقًا اجتماعات بين فصائل فلسطينية أفضت إلى ما سُمّي "إعلان بكين للوحدة الفلسطينية".
لكن، وبعد عامين فقط، لا تزال غزة تحت الحصار وتعاني المجاعة، والوحدة الفلسطينية غائبة، و"محور المقاومة" الذي تقوده إيران انهار بعد الحملة العسكرية الإسرائيلية الواسعة التي شملت قصفًا مباشرًا على إيران وسقوط نظام الأسد في ديسمبر 2024.
هذا التراجع السريع في تأثير الصين يعكس محدودية أهمية الشرق الأوسط في أولويات السياسة الخارجية لبكين. لا تستثمر القيادة الصينية وقتًا كبيرًا أو موارد كافية في تخطيط طويل الأمد للمنطقة، مما يجعل حضورها غير مستقر وردودها غالبًا متأخرة أو شكلية.
الأولويات الصينية
مثل كثير من الدول، تركّز القيادة الصينية على الشؤون الداخلية، من تعزيز الاستهلاك المحلي إلى إدارة الحزب الشيوعي. ويمكن الاستدلال على ترتيب الأولويات عبر اجتماعات المكتب السياسي، حيث تراجعت أهمية السياسة الخارجية بعد ولاية شي الأولى، وباتت أقل حضورًا من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا السياق، تظل الجغرافيا المحيطة بالصين هي التحدي الأكبر للسياسة الخارجية، إذ تواجه بكين جيرانًا مسلحين نوويًا وقضايا خلافية مع قوى عالمية مثل الولايات المتحدة. لذا تحظى الدول المجاورة والولايات المتحدة بالتركيز الأكبر، فيما تبقى منطقة الشرق الأوسط "أكثر المناطق أهمية ضمن الأقل أهمية" في السياسة الصينية.
رغم ذلك، تعتمد الصين على المنطقة في الحصول على 40-50% من وارداتها النفطية، كما وسّعت حضورها الاقتصادي ليشمل التعاون في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي. ومع ذلك، لا تصنّف بكين أيًا من قضايا الشرق الأوسط كـ"مصالح أساسية" مثل تايوان أو بحر الصين الجنوبي.
كذلك، تدعم دول عديدة في المنطقة مواقف الصين في قضايا مثل شينجيانج، بل تستخدم بعض الأنظمة العربية الممارسات الصينية كمبرر لقمع جماعات مثل الإخوان المسلمين.
في مجال أمن الطاقة، تنوّع الصين مورّديها، وتوقع عقودًا طويلة الأجل، وتوسّع قدراتها التخزينية وتوجهاتها نحو الكهرباء. وتشير تقارير إلى أن القلق من إغلاق مضيق هرمز خلال حرب الأيام الاثني عشر دفع الصين وروسيا إلى إعادة إحياء مشروع خط أنابيب "قوة سيبيريا 2".
السياسة المُفوّضة والنتائج
لأن المنطقة لا تمثل أولوية قصوى، تُفوّض القيادة الصينية إدارة السياسة تجاهها إلى مستويات أدنى، من وزارة الخارجية إلى الشركات الحكومية الكبرى. يؤدي هذا النموذج إلى نهج ردّ فعل غير منسق، حيث تصدر القرارات بصورة متقطعة تبعًا للأحداث.
تشير دراسات الخبراء الصينيين إلى أن سياسة بكين تعاني من ضعف التنسيق بين الوكالات وسلوك بيروقراطي معزول لا يشجع على التعاون الداخلي. كما أن الدبلوماسيين المتخصصين في الشرق الأوسط غالبًا لا يترقّون داخل الوزارة، مما يضعف تأثيرهم في صنع القرار.
في ظل غياب إجماع حول كيفية التعامل مع الولايات المتحدة في المنطقة، والانقسام بين دعاة المواجهة أو التهدئة، يظل الأداء الصيني مترددًا. وحتى من يطالبون بتحركات أكثر فاعلية، لا يقدّمون بدائل واضحة، مما يعكس عدم وجود إرادة سياسية على أعلى المستويات.
بالعودة إلى إنجازات الصين المعلنة مثل الوساطة بين إيران والسعودية أو "إعلان بكين"، تظهر القراءة الدقيقة أن هذه التحركات كانت رمزية في معظمها. إذ سبق للطرفين أن اتفقا على التهدئة قبل أن تدعوهم الصين، واختاروا بكين لأن لديها علاقات جيدة مع الطرفين، مما يمنحهم دعمًا إضافيًا. وبالنسبة للفصائل الفلسطينية، سعت بعض الأطراف لاستمالة الصين أكثر من اعتمادها على وساطة حقيقية.
يتسع نفوذ الصين عندما تتهيأ الظروف الإقليمية لذلك، لكنها لا تملك أدوات فاعلة للتأثير حين تتدهور الأمور بسرعة. ورغم أن بكين لا تُعتبر طرفًا يعتمد عليه وقت الأزمات، إلا أن قوتها الاقتصادية وموقعها في مجلس الأمن يجعلها جهة لا يمكن تجاهلها بعد انتهاء العواصف.
هل يتغيّر هذا النهج؟ التاريخ يشير إلى أن بكين يمكن أن تعيد التفكير إذا تعرّضت مصالحها لضرر مباشر، مثل إغلاق مضيق هرمز أو انهيار شامل في إيران. حتى ذلك الحين، ستواصل الصين أداءها غير المستقر في منطقة تتغير بسرعة، بينما تظل هي ثابتة في نهجها.
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/did-the-israel-iran-war-expose-chinas-middle-east-policy/